تستند مجموعة "جني الحواديت" إلى إطار حكائي يقوم على صالون ثقافي يستدعي جنيًّا راوياً يحكي سلسلة من القصص. هذا الإطار يتيح شكلاً من التجريب السردي عبر توظيف راوٍ خارق وتعدّد الأصوات داخل بنية واحدة، إضافةً إلى التماس مع روح الحكاية التراثية بصياغة معاصرة.
ورغم انفتاح هذا البناء على عوالم واسعة من التخييل، فإن الحواديت تميل غالبًا إلى الواقع القريب، مركِّزةً على موضوعات اجتماعية وأخلاقية مألوفة، ما يُحدث توتراً بين اتساع الفضاء الممكن عبر الجني وضيق التجارب المروية. وتتوزع القصص بين الواقعي والرمزي والسّاخر مع حضور ملحوظ للشفهية والحوار، بما يعيد إحياء نموذج الحكواتي في صيغة حديثة.
وتكمن قيمة المجموعة في تنويعها الموضوعاتي وخلقها تفاعلاً ميتاسردياً بين الجني ورواد الصالون، إلا أنّ بعض الحكايات تعيد إنتاج ثيمات تقليدية دون استثمار كامل لإمكانات الإطار التجريبي الذي بدأ به العمل.
ولعل الميزة في بنية التجريب هنا هي أن السرد لا يظل مغلقًا داخل عالم الحكاية فقط، بل يعتمد على تقنية العودة المستمرة إلى المجموعة المستمعة، (دكتورة سهير - الشاعرة والفنانة التشكيلية امال - الروائي أحمد عاصم - المهندس فريد) وكأنها جسر حيّ بين النصّ والمتلقي.
فتنشأ هذه الجدلية بين المتلقّي الأول والقارئ الضمني
وتتمثل أبرز تقنيات السرد التجريبي، في العودة المتكررة من الحكاية إلى المجموعة المستمعة داخل النص والتي تمثل المتلقي الأول. هذه التقنية تسعى إلى خلق فضاء حواري بين النص والمتلقي، بما يمنح الحكاية أبعادًا جديدة تتجاوز الحكاية ذاتها إلى مستويات من التلقي والتأويل. مما يمنحه دورًا مزدوجًا: كمتلقٍ أول للحكاية. ومنتج ثانوي للمعنى من خلال تعليقاته ومقارناته. والإسقاط على قضايا معاصرة، مثل قضايا المرأة أو قضايا اجتماعية أخرى، مما يضفي على النص طابعًا جدليًا بين الحكاية التقليدية والوعي الراهن. بهذا المعنى، يصبح وجودها وسيلة لقياس المسافة بين الماضي والحاضر، وبين الحكاية والواقع.
إلى جانب المتلقّي الأول، يتوجّه النص إلى قارئ ضمني خارج النص، هو المتلقي الذي يتصور الكاتب وجوده ويخاطبه ضمنيًا. هذا القارئ هو من يراقب البنية كاملة، إذ يتابع الحكاية، وتعليقات المجموعة، ويتأمل في تقاطع المستويين. ومن هنا فإن وجود الجماعة المستمعة لا يُلغي القارئ الضمني، بل يضاعف مستويات القراءة، ويمنحها عمقًا، إذ تُصبح الجماعة مرآة داخلية للقارئ الضمني، تقدم له مفاتيح للتأويل، لكنها لا تختزل تجربته. بل قد تعمل على تعدد النهايات مما يحولها من نهاية مغلقة الى نهاية مفتوحة.
ويشكّل الراوي (الجني) المحور المركزي للعمل السردي، غير أنّ التجريب يتجلّى في إدخال أصوات الجماعة المستمعة، التي تقطع سياق الحكاية للتعليق عليها وربطها بالواقع. هذه العودة ليست ترفًا شكليًا، بل أداة فنية لإعادة إنتاج المعنى، حيث تتحول الجماعة من مجرد متلقٍ سلبي إلى عنصر فاعل في تشكيل الدِلالة.
تكمن القيمة لهذا الأسلوب في كونه يربط الماضي بالحاضر، ويستثمر البنية التقليدية للحكاية في ضوء أسئلة معاصرة. فالحكاية لا تبقى حبيسة زمنها، بل تُعَرَّض للتفكيك والنقد عبر تعليقات المستمعين، لتتحول إلى أداة لإثارة وعي اجتماعي وفكري، خصوصًا في القضايا الأكثر إلحاحًا مثل قضايا المرأة، التي تبرز كأحد أهم المداخل لإعادة قراءة الواقع.
إن السرد التجريبي الذي يوظف تقنية العودة إلى الجماعة المستمعة يحقق جدلية فنية وفكرية في آن واحد: فهو من ناحية يفتح النص على تعدد الأصوات، ومن ناحية أخرى يمنح القارئ الضمني فرصة للتأمل في مستويات المعنى. وبذلك يتأسس النص على ديناميكية مستمرة بين الراوي والمستمعين والقارئ الخارجي، بما يجعل الحكاية فضاءً للحوار والنقد، لا مجرد سرد تقليدي للأحداث.
ويمكن تقسيم الوظائف الفنية لهذا النوع من السرد التجريبي المعاصر إلى..
أولًا: الوظائف الفنية
كسر خطية السرد: حيث تقطع الجماعة تدفق الحكاية، فتمنح النص حيوية وتعددًا في الأصوات.
تفعيل التلقي المباشر: يصبح المستمعون طرفًا مشاركًا في إنتاج المعنى، لا مجرد مستقبلين سلبيين.
الإسقاط على الحاضر: يتيح التعليق إسقاط الحكايات القديمة على قضايا معاصرة، وهو ما يضاعف من طاقة النص النقدية حيث تتجسد مواجهة بين تراث الحكاية الشعبية والوعي الراهن للقضايا المعاصرة (العدالة الاجتماعية والمرأة.)
ثانيًا: مستويات التلقي
المستمعون كمتلقّي أول:
يتجاوزون دور المتلقي المباشر للحكاية، إلى التحليل والتعليق، وبذلك يصبحون شركاء في إنتاج الدلالة.
القارئ الضمني:
يظل النص موجَّهًا إليه، بعد أن يمنح مفاتيح جديدة للتأويل
وتتمثل القيمة الأساسية لهذا الأسلوب في أنه يوظف الحكاية التقليدية في أفق جديد كأداة لتفكيك الواقع الراهن وإعادة قراءته. وهكذا يحقق النص بعدًا نقديًا مزدوجًا: فهو من ناحية يخلخل أنماط السرد التقليدي، ومن ناحية أخرى يثير أسئلة فكرية واجتماعية ملحّة.
تتعدد المضامين التي يتناولها النص
ويمكن تقسيم النص لثيمات عامة
1 – ثيمة الإنسان وصراعه مع الوجود والموت
قصص مثل "حوار مع ملك الموت ص9" و*"بندقية بحر ص17"* و حتى*"البداية ص5"* تستكشف أسئلة الوجود، الفناء، والخوف من النهاية.
يظهر الإنسان دائمًا في مواجهة قوى كبرى: البحر، الموت، القدر، أو المجهول.
حيث تبرز فكرة هشاشة الحياة مقابل رغبة الإنسان في البقاء.
2 - العلاقات الاجتماعية والمرأة
قصص مثل "حب فيسبوكي ص7", "مدام فيفي ص26 ", "ستيلا ص13", وأجزاء أخرى تنتقد أو تصوّر تحولات أدوار المرأة، والزواج، والخيانة، والطلاق.
تعدد اشكال الصراع التقليدي والحديث، وأثر التكنولوجيا (مثل الفيسبوك) على العلاقات.
المرأة تظهر رمزًا للتحرر أحيانًا، وضحية لتغير المجتمع أحيانًا أخرى.
3 - الفساد والصراع الأخلاقي في المجتمع
قصص,"كيدهن عظيم ص82" وغيرها تكشف فسادًا إداريًا أو أخلاقيًا: مؤامرات، خيانة، استغلال، وصدام بين القيم.
هذه الثيمة تطرح تساؤلات حول العدالة، ضمير الفرد، ودور القانون.
تظهر الشخصيات عالقة بين مصالح شخصية وواجبات أخلاقية.
كما يمكن تقسيم النص بحسب الموضوعات والفضاءات التي تدور فيها
- حواديت الطريق والمركبات
قصص تدور أحداثها على الطريق أو داخل وسائل المواصلات، حيث تصبح المركبة فضاءً دراميًا يكشف التوتر الإنساني والاجتماعي:
"السيارة الجديدة ص 132، تاكسي ص138، ميكروباص ص 146، أوتوستوب ص71، فتجان كاكاو، فعل فاضح،بندقية بحر ص 17 (لأنها تدور في رحلة صيد وسفر داخلي
2 – حواديت على طريقة السينما القديمة
قصص تقترب في أجوائها أو مشاهدها من روح الأفلام المصرية الكلاسيكية أو العالمية، فيها لمسات درامية مألوفة وسينمائية:
"مدام فيفي ص26" (تشبه الميلودراما الاجتماعية التي عرفتها السينما المصرية)
"مدام نيرفانا ص40" (بطابعها الجريء وفضاءاتها المغلقة كأنها مشاهد من فيلم)
"كيدهن عظيم ص82" (أجواء مكائد وخدع قريبة من الحبكات السينمائية)
"حب فيسبوكي ص7 (تستعير من الميلودراما الرومانسية مع تحديثها بالفضاء الافتراضي)
3 - حواديت الغرابة والرمزية
قصص تتجاوز الواقع المباشر إلى الغرائبي أو الرمزي، بما فيها إسقاطات فلسفية أو خيالية:
البداية (ظهور الجني راو راوي الحواديت)
"حوار مع ملك الموت ص9" (تمثيل رمزي للموت والحساب)
"ستيلا ص13" (تُروى بلسان كلب، أي منظور غير إنساني)
- ملاحظات نقديّة على "جني الحواديت"
1 - المجموعة المستمعة
يضم الإطار الحواري شخصيات ذات خلفيّة ثقافيّة عالية: دكتورة، شاعرة، روائي، مهندس. وربما كان من الأنسب – بحكم استخدام لفظة "الحواديت" المرتبطة تقليديًا بالحكي الشعبي – أن تكون المجموعة المستمعة أقرب إلى ربّات بيوت، عمال مقهى، أو حتى أطفال.
غير أنّ استبعاد الأطفال يبدو مفهومًا نظرًا لاشتمال النص على موضوعات لا تناسبهم (+18) وتناول قضايا سياسية واقتصادية وتاريخية.
ومع ذلك، يبقى الإطار الحالي في تعارض نسبي مع البنية المرجعية لمفردات: «توتة توتة» أو «يا سادة يا كرام» التي ترتبط بطقس سردي شعبي لا نخبة ثقافية أكاديمية.حدوتة الأولى
2 - امتداد الأزمنة وتشتت الحدث:
تتوزع الحواديت على أزمنة متباينة، غير أنّ معالجة الزمن داخل عدد من النصوص تتسم بالامتداد والتفصيل الذي يخرجها من إطار القصة القصيرة نحو جنسٍ أقرب إلى النوفيلا أو الرواية القصيرة، لا سيما في آخر ثلاث حكايات التي تتسع فيها الأحداث والشخصيات على نحو لا ينسجم تمامًا مع طبيعة الحكي المتتابع داخل الإطار العام. هذا الاتساع السردي، مقترنًا بتراجع التكثيف الدرامي، يثير سؤالًا جماليًا حول مدى ملاءمة هذا البناء لطبيعة المجموعة التي تستند إلى راوٍ خارق يُنتظر منه تقديم حكايات قصيرة متنوّعة الإيقاع والزمن، لا سردًا ممتدًا يقترب من شكل رواية داخل الرواية. ويعزّز هذا التساؤل ما يطرحه الجني بنفسه في صفحة 127: «هل ما أسرده عليكم يحدث في مجتمعاتكم أم لا؟»؛ إذ يُبرز محدوديّة الفضاء الحكائي في الواقع المحلي، رغم ما يتيحه حضور الجني من فرص للتنقّل السردي بين أمكنة وأزمنة وعوالم أخرى، كان من الممكن استثمارها لابتكار سرديات أكثر انفتاحًا على المعاصر والتقني، مثل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.
3 – الغلاف
يمثل إشكالية في وظيفة الجني واعتماد هعلى الذاكرة
يظهر الجني على الغلاف حاملًا للكتب، غير أنّ دوره داخل المتن يخالف هذه الإشارة البصرية؛ إذ لا يقرأ من كتب ولا يستدعي معارف واسعة، بل يكتفي بالحكي من ذاكرته. ورغم أنّ هذا يعزز طابع الحكواتي الشعبي، فإنه لا ينسجم مع طبيعة الجني ككائن خارق يُفترض أن يمتلك قدرة على النفاذ إلى عوالم مختلفة ورواية سرديات غير مألوفة.
وفوق ذلك، تأتي غالبية الحكايات تقليدية في موضوعاتها ونمطها ومعالجتها، مما لا يستدعي تدوينها بوصفها "حدثًا" مستحقًا للحفظ؛ فبدل أن يقدّم الجني قصصًا فريدة من عالمه أو من تجارب غير متاحة للبشر، ينحصر في سرد وقائع قريبة من اليومي والمعتاد.
4- تكرار الأسماء
يُلحَظ تكرار بعض الأسماء مثل: كوثر، عمر، عصام، رمزي.
ورغم احتمال التعمد لخلق صدى داخلي، فإن التكرار غير المؤسَّس قد يُربك القارئ أو يضعف التمييز بين الشخصيات.
5- دقة المصطلح التاريخي
ورد استخدام كلمة «مترو الأنفاق» في سياق أحداث تعود إلى عام 1973، بينما لم تُفتتح المرحلة الأولى من المترو إلا في 1987، ما يشير إلى فجوة زمنية في المرجعية التاريخية.
6- منطقية شخصية الجني
في الحدوته التاسعة، يشتكي الجني للمرة الثانية من البرد ويطلب مشروب الجنزبيل، بل تُغلق النوافذ إرضاءً له.
يثير ذلك تساؤلًا حول منطق الشخصية:
كيف يعجز جنيّ – بصفته كائنًا خارقًا – عن توفير الدفء أو الشراب لنفسه؟
هل هو جنيّ مقصور الوظيفة على السرد فقط ولا يمتلك قدرات أخرى؟
هذا التفصيل يفتح بابًا للتأويل لكنه قد يخلق خللاً منطقيًا ما لم يُسند بطرح رمزي أو دلالي مقنع.
ومن كل ما سبق، تظهر "جني الحواديت" لا بوصفها استعادة بريئة لمرويات قديمة، بل مشروعًا سرديًا واعيًا يعيد توظيف الحكاية الشعبية في أفق جديد؛ إذ تتحول الحواديت من مادة للتسلية إلى أداة للجدل والتفكير، ومن صوت واحد يحكي إلى أصوات متعددة تحاور وتسائل.
وبين المتلقّي الأول داخل النص، والقارئ الضمني خارجه، تتشكل المسافة الحية التي تمنح التجربة معناها الحقيقي: فليست قيمة الحكاية فيما ترويه، بل فيما توقظه فينا من أسئلة، وما تفتحه من نوافذ على واقعنا الراهن.
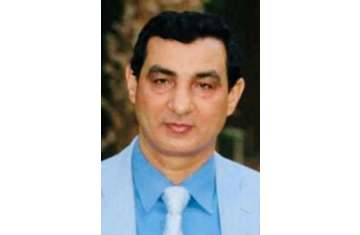
التعليقات