-1-
يذكر المستشرق الإنجليزي إدوارد وليم لين في كتابه: “المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم في القرن التاسع عشر”، حكاية لافتة جدا للنظر، سأنقلها بتصرف بسيط جدا، معتمدا في سردها، وطوال هذه الدراسة، على الطبعة الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ما لم يضطرني سبب هام إلى العودة للنص الأصلي. وأسارع فأعترف بأنني لا أميل إلى تصديق حكاية المستشرق بكل تفاصيلها، ولا أجزم أيضا، لعدم وجود دليل نفي مؤكد، بأنه قد انتحل بعضها انتحالا.
يبتدئ إدوارد حكايته بملاحظة شديدة العمومية؛ وهي أن المصريين يكررون اسم الله في أغانيهم الماجنة، مستشهدا بمقطوعة من أحد الموشحات أورد ترجمتها في كتابه (أو بآخر ثلاثة مقاطع من قصيدة كما في النص الأصلي) كمثال للطريقة الغريبة التي يختلط بها الفجور بالدين في الأدب العامي المصري، ذلك الذي لم يذكر شيئا عنه في الفصل المخصص للآداب في الكتاب نفسه، وفي هذه المقطوعة (لم يُترجم إلى العربية في طبعة الهيئة إلا مقطعان فقط من الثلاثة) يتحدث الشاعر عن فتاته التي يقابلها بعد هجر، واصفا إياها بأنها أرشق من غصن البان، وبأن المسك والعنبر يفوحان منها؛ فيقبَّل خدها وثناياها، ويرن الكأس في يده، ثم يقضيان معا أوقاتا سعيدة، بعدها يستغفر الشاعر ربه على خطاياه، ويقهره الحزن؛ فلا يجد له أملا في النجاة إلا الله الغفور الكريم، هذه هي خلاصة ما ترجمه عدلي طاهر نور. ويضيف المستشرق بنبرة مؤثرة -لا أتخيلها إلا معممة، وذات لحية بيضاء طويلة، وفي يدها مسبحة- أن صديقا مسلما زاره بعد كتابة الملاحظات السابقة؛ فسأله بعد أن قرأ عليه القصيدة (أو أربعة مقاطع منها كما في النص الأصلي):

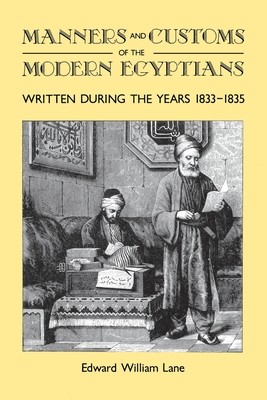
– أيليق أن يُمزج الدين بالخلاعة هكذا؟
ليحصل منه في الحال على إجابة قاطعة:
– نعم، يليق كل اللياقة.
وهنا يداعب المستشرق لحية نبرته بيسراه، فيما يداعب بيمناه حبات مسبحتها قائلا:
– ولكن هذه قصيدة قيلت لتسلية هؤلاء الذين ينهمكون في الملذات المحرمة.
يتوصل إدوارد، بعد تفكير عميق، إلى هذا الاستنتاج، ويريدنا أن نتعامل معه، إن كان فعلا قد قاله لصديقه المسلم، وكأنه الاستنتاج الوحيد الممكن، ثم يتابع، دون أن نعرف أوافق صديقه هذا على استنتاجه السابق، أم عارضه: – لاحظ أن الصفحة التي تصف الفسق تقابل التي تذكر أسماء الله عندما أطوي الكتاب فيكون وصف الملذات الأثيمة فوق ذكر الاستغفار. هو إذن يتحدث عن ديوان شعر عامي مطبوع، أو منسوخ على أقل تقدير؛ فلماذا وهو المولع بالتفاصيل لم يذكر اسم مؤلفه؟ أخَشي -مثلا- أن تفسد حكايته بسبب تعميم حكمه على المصريين؟ وإذا كان الديوان جامعا للأغاني والموشحات العامية فلماذا لم يذكر اسمه، أو اسم جامعه؟ ولماذا فاته أن يذكر جنسية صديقه المسلم، الذي يبدو -إن كان وجوده حقيقيا، ولتستقيم الحكاية أيضا- أنه مصري لا يستطيع أجنبي أن يخدعه بسهولة، يدل على ذلك رده على سؤال الخواجة لين: – ذلك عبث. اقلب الكتاب جاعلا أسفله أعلاه ينعكس الحال فيغطي الغفران المعصية. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: “قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم”.


ثم يستكمل إدوارد استنتاجاته: “وقد ذكرتني إجابته ما لاحظته كثيرا من أن غالبية العرب، وهم شعب كثير التناقض، يستمرون في مخالفة الشرع اعتمادا على أن عبارة: “أستغفر الله العظيم” تمحو كل خطيئة. ولا يعني هذا إطلاقا تقليلي من شأن إدوارد وليم لين؛ فالرجل -رغم سوءاته التي سأتحدث عنها- لا يستطيع القارئ المنصف إلا أن يعترف بأهميته، ولسوف يتطلب الأمر أحيانا مقارنته بآخر كتب في نفس الموضوع هو جاسبار دي شابرول صاحب كتاب “دراسة في عادات وتقاليد سكان مصر المحدثين”، وهو أحد كتب مجموعة “وصف مصر”، وقد طبعته الهيئة أيضا، لكنني سأعتمد على نسخة مطبعة الجبلاوي التي صدرت عام 1976م. ولا يسعني، قبل أن أبدأ، إلا أن أشكر القائمين في الهيئة العامة لقصور الثقافة على إخراج وتحرير هذا الكتاب المهم. ولكم وددت ألا يحذفوا منه شيئا. ولا يسعني -أيضا- إلا أن أنبه إلى خطأين تحريرين مهمين: أولهما، سقوط كلمة “أولياء” من الآية الكريمة الواردة في بداية الفصل الثالث عشر؛ لإضافتها في الطبعات اللاحقة، وثانيهما، كتابة واو العطف بدلا من “إنه” في الآية التي استشهدت بها في هذا الجزء.
-2-
لم يسلم إدوارد وليم لين من تأثره الشديد بشمائل وعادات المصريين المحدثين في القرن التاسع عشر، بل أجزم بأن بعضا من سلوكياته كإنجليزي مثقف قد تغير تماما من النقيض للنقيض، ودليلي على ذلك مثالان من كتابه: الأول، ما ذكره في الفصل الثالث عشر المعنون بالأخلاق: “وكثيرا ما يشاهد المرء، في المجتمع المصري، ناسا يتلون آيات وأحاديث تناسب المقام؛ ولا يعتبر مثل هذا الاقتباس، كما هو الحال في مجتمعنا نفاقا أو مملا، وإنما يثير إعجاب المستمعين ويصرفهم عن تافه الحديث إلى جده”. إدوارد في الفقرة السابقة يحدثنا عن صفة أصيلة في المجتمع الإنجليزي؛ ألا وهي: عدم ذكر آيات أو أحاديث تناسب المقام؛ لأن هذا السلوك الذي تكثر مشاهدته في مصر يعتبره الجنتلمان الإنجليزي نفاقا أو مملا، ولا يدفعنا ذلك إلا إلى التعجب؛ فما أكثرها تلك الآيات التي استشهد فيها لين بالكتاب المقدس! ولا يغرنكم بعض مواضع استشهاداته تلك في النسخة العربية من كتابه، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما أورده في الصفحة رقم ١١٠، تعقيبا على النص الآتي:


“تبدأ أم الراغب في الزواج أو إحدى قريباته بوصف الفتاة التي تكون عرفتها وذكر أحوالها، وترشده في اختياره”، مستشهدا بالآتي: “وكان إرسال إبراهيم رسولا إلى بلده للبحث عن امرأة لإسحق ابنه (انظر سفر التكوين ٢٤) يعتبر تماما عين الوسيلة التي قد يتبعها العرب المحدثون في مثل هذه الظروف لو تيسر الأمر لهم. ويتلو أيضا تعقيبا على معارضة الأب المصري لتزويج ابنته الصغرى قبل الكبرى: “فقال لابان لا يفعل هكذا في مكاننا أن تعطى الصغيرة قبل البكر”. الشيء الثاني الذي لم يسلم منه المستشرق الإنحليزي هو تأثره الشديد بالسحر في مصر، وحكايته مع الساحر عبد القادر المغربي، تلك التي أفرد لها عدة صفحات في كتابه تكفي وزيادة؛ لذا لا تستغربوا تلك الكلمات الحارة الصادقة التي اختتمَ بها تلك الحكاية: “ورجائي من القارئ، إذا كان مثلنا عاجزا عن إيجاد الحل، ألا يدع البيان السابق يثير في ذهنه ريبة فيما يتعلق بأحزاء الكتاب الأخرى”. هذا ما ترجاه المستشرق من قارئه، أما أنا فرجائي من قرائنا أن يحرصوا على فهم شخصية ودوافع من كتب عنا؛ ليزيلوا عن أعينهم غشاوة الانبهار المطلق بكتاباتهم. وسأتحدث في الأجزاء التالية ببعض التفصيل -ومستعينا للمقارنة، حينما يتطلب الأمر ذلك، بأجزاء من كتاب جاسبار دي شابرول المذكور- عن عيوب شديدة الخطورة عند وليم كتعمده لإخفاء بعض الحقائق، وإساءته لفهم بعض الأمور، وغير ذلك مما سيرد ذكره في حينه.
–3-
يبتدئ جاسبار دي شابرول ذلك الفصل من كتابه: “دراسة في عادات وتقاليد سكان مصر المحدثين”، الذي خصصه لرياضة وألعاب المصريين بالآتي: “تتفق ألعاب الشرقيين مع حدة طباعهم”، وكان قد وصفها قبل صفحات بالخلاعة والتهور والوحشية، ويضيف واصفا كل شيء عن إحدى هذه الألعاب في هذه الأسطر القليلةالتالية: “وثمة ألعاب أخرى تتطلب شيئا من التأمل، وتنتشر هناك لعبة المنقلة، ويلعبها اثنان مع كل واحد منهما لوحان حفرت فيهما ستة ثقوب، ويضع اللاعبان في كل ثقب من هذه الثقوب ست قطع من الحجارة أو مثلها من الزلط”. ويقول في الفصل ذاته، الذي لا يستغرق إلا أربع صفحات فقط من الكتاب: “لكنا للأسف أهملنا القواعد التي تنظم هذه الألعاب ولعل الكثيرين من قرائنا سوف يغفرون لنا عن طيب خاطر هذا التقصير من جانبنا”.


أما إدوارد فيقول في الفصل المخصص للألعاب: “إن أكثر ألعاب المصريين تلائم طباعهم الهادئة”، ثم يذكر -فيما يذكر- لعبة المنقلة، واصفا إياها بالتفصيل في أكثر من صفحتين، مع العلم أن الصفحة في كتاب لين تزيد في عدد الأسطر عنها في كتاب جاسبار، وتقل في حجم البنط. ولعلكم لاحظتم ذلك التناقض الكبير في رؤية كل من الرجلين لطباع المصريين. ولا نحتاج لتفسير ذلك التناقض إلى جهد؛ فالأول أتى مع الاحتلال الفرنسي لمصر، محاطا بالعديد ممن يرتدون الملابس العسكرية، أما الأخير فأتى قبل الاحتلال الإنجليزي بعقود، مفضلا ارتداء ملابس لا تخصه؛ لأنها أكثر ملاءمة له حسب زعمه، تلك الملابس التي جعلت العامة يظنونه تركيا. ولعل التقصير الذي اعترف به جاسبار لقرائه هو الذي هيأ لصاحبنا الإنجليزي أسبابا ودوافع لعدم الاكتفاء بما توصل إليه زميله الفرنسي. يتبقى شيء آخر لم يذكره لين إطلاقا في كتابه، ولكنه ذكر بفخر إحدى نتائجه، هذا الشيء هو مجيء الأسطول الإنجليزي للأسكندرية، قبل يوم واحد من مجيء ما يطيب للبعض تسميته بالحملة الفرنسية، وتحذيرهم لمصريي هذا العصر من نوايا الأسطول الفرنسي الشريرة، بل وعرضهم المساعدة على المصريين، إلا أن المصريين وقتها كانوا أذكى من قبول هذا العرض، بالإضافة إلى ما تم بعد ذلك من أحداث، وأما النتيجة التي افتخر بها إدوارد لين متنكرا لسببها فقد أوردها في الصفحة رقم ٢٣٨ حيث يقول: “ويمكنني أن أذكر هنا، وأنا أشعر بالفخر، الحادث التالي: “كان في القاهرة صائغ أرمني اشتهر بالصدق إلى درجة أن عملاءه قرروا تسميته اسما يدل على تمتعه بفضيلة قلما توجد فيهم؛ فلقبوه بالإنجليزي”. والآن، وقد قارب هذا الجزء على الانتهاء، لا يسعني إلا الدخول في الجزء التالي إلى صلب الموضوع.
-4-
تختلف إساءة الفهم عند ثنائيينا: جاسبار دي شابرول، وإدوارد وليم لين اختلافا جوهريا، وأحسب أن ذلك يعود إلى سببين أوليين: اللغة، والفضول. ولا يمنع هذا -بطبيعة الحال- من وجود أسباب أخرى أكثر أهمية، سأتحدث عنها في موضعها؛ فالأول -كما أخبرنا بين ثنايا كتابه- لم يكن يعرف من العربية ما يكفي لكي يفهم عرضا تمثيليا، ووجد أن ليس ما يدعو لعناء أن يُتَرجم له معنى التمثيلية التي ذهب لمشاهدتها، أما الثاني فله ترجمته الشهيرة لكتاب “ألف ليلة وليلة”، وله لوحاته التي توضح إلى أي مدى كان ولعه بالتفاصيل، ولكن لكل منهما إساءة فهمه الخاصة كما أسلفت؛ يتحدث جاسبار في كتابه “دراسة في عادات وتقاليد سكان مصر المحدثين” قائلا: “فالمسلمون على سبيل المثال ينتظرون أولى بشائر الفيضان والاحتفالات التي يقوم بها الناس في هذه المناسبة لكي يحتفلوا بأعراسهم ويستمر حتى حلول شهر رمضان، ومن النادر أن يتزوجوا قبل أو بعد هذه الفترة التي يبدو أن العادة هي التي حددتها”. ولعلكم لاحظتم أن الفقرة السابقة لا يستقيم أمرها إلا إذا تساوت السنتان: الميلادية والهجرية، وهذا غير صحيح بالكلية؛ لأن شهر رمضان يتعاقب على كل شهور السنة الميلادية، أما الفيضان فلا يأتي إلا في شهور ميلادية محددة؛ أي أن الفترة المذكورة قد تمتد إلى أحد عشر شهرا هجريا، كأن تأتي أولى البشائر في عيد الفطر ، وقد تتقلص إلى يوم أو اقل، كأن تتوافق أولى البشائر مع الليلة السابقة لثبوت رؤية الهلال، أو مع فجر أول أيام رمضان.


والسؤال الآن: كيف لشخص مثل جاسبار أن يسيء الفهم إلى هذه الدرجة؟ والإجابة في رأيي تحتاج إلى العودة عدة خطوات للوراء؛ ففي حديثه عن العادات والتقاليد بشكل عام كتب قائلا: “لا يمكنك أن تكتشف ما يعتمل في نفس المصريين عن طريق ملامحهم. فصورة الوجه ليست مرآة لأفكارهم” ، وبعد أسطر يكمل: “ويمكننا أن نتلمس أسبابا عديدة لهذا الجمود في الملامح، قد لا يكون الطقس بعيدا عنها، فحيث يبدو الطقس على الدوام بنفس الشكل، فإنه ينقل إلى النفوس على نحو ما ثباته الدائم”، تلك إذن كانت نقطة انطلاقه في دراسته؛ فتقاليد المصريين عنده هي وليدة النظامين: السياسي والديني، “ومما لا جدال فيه أن معظم قوانينهم تقوم على معرفة دقيقة بالطقس وأنها تبدو متمثلة تماما لطبائع الناس وكذلك للموقع الجغرافي للبلاد”، والمجتمع -عنده- ليس هو الذي ينظم التقاليد في مصر؛ “فكل شيء فيه يستند إلى النظام الروحي والديني ويظل -مثله- في حالة من الثبات لا تقبل التغيير”، لا وجود إذن للتغيير أو للمجتمع في معادلته، مكتفيا فقط بالنظم المذكورة وبالطقس، وهذا ما جعله يري الطقس ثابتا ليفسر بثباته جمود ملامح المصريين، أو العكس، وهذا بعينه ما دفعه دفعا ليحدد، بتسرع شديد جدا، الفترة ما بين أولى بشائر الفيضان وحلول رمضان لزواج المصريين، أما إدوارد وليم لين فالعادات عنده ليست ثابتة، بل قابلة للتغير، وقد أكد ذلك في ملحق المحدثات الأخيرة: “إن العادات الأوروبية لم تأخذ بعد في الانتشار بين المصريين أنفسهم، ولكنها لن تلبث أن تنتشر”، وقد لا يستغرق تغيير العادة وقتا طويلا، كأن يلحظ عادة ما في زيارته الأولي لمصر، ثم يكتشف اختفاءها في زيارة تالية، ولا يفوتنا هنا أن نأخذ عليه المقطع الأخير في عنوان كتابه “في القرن التاسع عشر”. للرجل، إذن، معادلته العقلية المختلفة، التي أخرج الثبات منها تماما، وأخرج منها التعويل المبالغ فيه على الطقس، ليدخل النص الديني صراحة أو ضمنا في معادلته؛ فنراه في الفصل الرابع والعشرين يقول:
“ومن العادات الشائعة أن يتصدق المصريون المسلمون بما في طاقتهم طول شهر المحرم؛ وهم يتصدقون خاصة في الأيام العشرة، وعلى الأخص في اليوم العاشر. ويدعي كثير منهم أنهم يؤدون الزكاة في هذا الموسم، وقل من يفعل ذلك حقا؛ فهم لا يتقيدون بغير إرادتهم، يعطون من يشاءون ما يشاءون”، ثم يعقب على كلامه هذا في الهامش بقوله: “يبدو أن تلك العادة نقلت عن اليهود الذين تعودوا التصدق وعمل الخير أثناء الأيام العشرة، التي تبدأ برأس السنة الجديدة وتنتهي بيوم الاستغفار، أكثر من أي يوم آخر”. ولكم وددنا أن نعرف المقياس الذي استخدمه إدوارد ليؤكد به كذب إدعاء مخرجي الزكاة في هذا التوقيت، لكننا على يقين من أنه تكلف أشياء لا علاقة لها بالملاحظة، أو بالعلم، لإثبات، أو لفرض قناعة شخصية لا تخص أحدا غيره، ومن يعد قراءة فقرتيه السابقتين سيلحظ أن شهر المحرم هو بداية السنة الهجرية، ولا يحتاج الأمر إلى ذكاء لتخمين أن يوم الاستغفار الذي ذكره يقع في اليوم العاشر. ثمة موضع آخر في كتابه أساء فيه الفهم؛ فهاهو يخبرنا بما قيل له في أثناء زيارته للمشهد الحسيني، وكان الحشد يدفعه -كما يقول- نحو امرأة شابة: “يا عيني لا تكبس عليَّ بشدة هكذا”، ولا يكتفي بكتابة “وإن بدت عيناها النجلاوين تبتسمان معبرتين عن تسليتها”، بل يضيف في الهامش موضحا كلمة عيني في جملة المرأة: “وهو تعبير دارج يدل على المحبة ويعني: أنت يا من تعز عليَّ مثل عيني”. وأختتم هذا الجزء بإساءة فهم طريفة لإدوارد، يقول فيها في الفصل السادس: “وفي أكثر الأحيان لا يصلي العريس مطلقا، أو يصلي من غير وضوء، مثل المماليك الذين يقيمون صلاتهم خوفا من سادتهم فقط”، وهنا نسأله للمرة الثانية: كيف عرفت أن العريس صلى بدون وضوء يا إدوارد؟ واردٌ جدا أن يكون قد ظن أن لكل صلاة مستقلة وضوءها المستقل؛ فأساء الفهم، إلا أن النص الأصلي يدحض بشدة هذا الاحتمال.
-5-
أدخل إدوارد، إذن، مرجعيته الدينية الخاصة كلاعب أساسي في معادلته الفكرية، عوضا عن الطقس الذي أجلسه لفترات طويلة جدا على دكة البدلاء، وكان لمرجعيته الدينية تلك تأثيرها الخطير على سير المباراة ونتيجتها؛ يقول، على سبيل المثال، في فصل الخرافات: “ويروي الكثير من المسلمين أن إلياس، ويخلطه العامة بالخضر، كان قطب زمانه،…، ويبدو أن اعتقادهم في القطب مأخوذ مما قُص علينا في التوراة عن إلياس ورفعه إلى السماء”. ولست هنا لأناقش مصداقية خلط العامة هذا الذي حدثنا عنه، بل لأشير إلى تأثره بمرجعيته الدينية الخاصة في بحث ميداني لا يحتمل ذلك، وتجاهله التام والغريب للتفرقة التي أكدها القرآن -وهو كتاب الأغلبية موضوع الدراسة- بين إلياس والخضر. فهل كان الرجل جاهلا بالقرآن؟ هو بنفسه أجابنا عن هذا السؤال، حيث كتب في موضع آخر من الفصل نفسه: “ويبدو هذا مناقضا لما نقرأه في عدة مواضع من القرآن”. والحق أنني لم أذكر الفقرة السابقة لأشير إلى ما أشرت إليه فقط، بل لأنوه إلى ما هو أهم منها وأغرب؛ فقد ساوى إدوارد، بتحايل غريب جدا، بين العرب الغربان، فعل ذلك بعد أسطر قليلة، بإقحامه لنصين دينيين لتفسير ظاهرة اجتماعية بعيدة كل البعد عنهما، مع تجاهله التام للإزاحات المهمة في ظاهرته؛ يقول إدوارد:
“وهذا يذكرنا مرة أخرى بقصة إلياس، إذا وضعنا، كما يرى بعض الناقدين، كلمة (عرب) بدلا من لفظة (غربان) في الآيتين الرابعة والسادسة من الإصحاح السابع عشر من سفر الملوك الثاني: “وقد أمرت ( العرب ) أن تعولك” ، “وكانت (العرب) تأتي إليه بخبز”، ولم يكتف إدوارد باستبدال كلمة الغربان بكلمة العرب، بل استبدل أيضا الأولياء بإيليَّا التشبِّي، وما ذلك إلا لأن الأولياء زهدوا في ملذات الدنيا وصحبة ناسها، فعكفوا على التأمل منقطعين للصلاة، ولهذا تكفلت العناية الإلهية بتسخير من يسد حاجتهم. ولأن الإعالة لا تكون إلا لحي كان ولابد أن يقسم الأولياء إلى أحياء وأموات، “وأكثر أولياء مصر المشهورين -والكلام لإدوارد- معتوهون أو بله أو خداعون. ويسير بعضهم عراة تقريبا”. ولولا التزامي بطبعة الهيئة لاستدللت بموشحة من النص الأصلي، لم يثبت إدوارد نطقها العربي بأحرف إنجليزية، كما فعل مع أشعار أخرى، وإنما ترجمها ترجمة تدعو للاستغراب، ليربط بينها وبين نشيد سليمان، ثم رأى المترجم حذفها فألزمنا بما رآه. ولعلكم لاحظت أنني لم أذكر الاستعمار ضمن قائمة اللاعبين الأساسيين في معادلتي كل من جاسبار وإدوارد الفكريتين؛ فهذه حقيقة من نافلة القول ذكرها، وأضيف إلى ما سبق الظرف التاريخي المصاحب لوجود كل منهما في مصر، وعلوم ومعارف عصرهما، وإلا تشددنا في تقييمنا لمعادلة إدواردية ورد ذكرها في الكتاب؛ وهي: (الأقباط) الذين أسلموا + (القبائل العربية) الآتية من أماكن وأزمنة مختلفة = (قدماء المصريين) الذين نسبهم إلى أصل قوقازي، “مع قرابتهم إلى الجنس الأسود على درجات مختلفة”. وللأمانة فقد عبَّر إدوارد عن علامة “=” بلفظي كثير الشبه. ولو أن حفيدا لأحد الروحانيين الذين ورد ذكرهم في كتاب إدوارد حَضّر لنا الآن عفريته، (وهو الذي قلما يرتبك في مناقشة ما)، مواجها إياه بكلامي هذا، وبما توصل إليه عصرنا من علوم، وبخاصة في الهندسة الوراثية، لقال على الفور: هذه الجملة المائلة التي بين القوسين أصلها يعود لي. أنا واثق تماما مما أقول.
-6-
يقوم أسلوب الكتابة أحيانا بالدور نفسه الذي يقوم به الجسد. وما المتأمِّل لوجه وجسد ودرجة صوت الأسلوب إلا كقارئ لغة الجسد تماما، حيث يمكنه -بقليل من المران- الوصول إلى ما وراء الكلمات من الخفايا. ولأننا لسنا بصدد دراسة أسلوبية لكتاب إدوارد وليم المشار إليه؛ فالكتاب قد كتب أساسا باللغة الإنجليزية، لكن الرجوع إلى النص الأصلي سيظل متاحا طوال الوقت، لمعرفة الكيفية التي تعامل بها المترجم مع جملة ما. وبالمناسبة: لا وجود في العنوان الأصلي لجملة “في القرن التاسع عشر”، بل لجملة ” كتب في مصر بين عامي ١٨٣٣ و ١٨٣٥م، وهذا يجعلني أتراجع عن مؤاخذتي لإدوارد لإضافته تلك الفقرة في العنوان.
سأكتفي، إذن، برصد القليل من تبريراته، والقليل أيضا من الأجزاء الدالة في جمله، وسنرى معا أين يقودنا هذا الرصد. يقول إدوارد مبررا اختياره للملابس التركية: “وجدتها أكثر ملاءمة لي”، ويقول في فصل الأعياد الدورية العامة: “وتملكني شعور جامح يدفعني إلى محاولة القيام بالذكر مثلهم دون أن يتبين أمري؛ فانضممت إلى الجماعة، وقد نجحت في ذلك إلى حد لا يثير الشبهة، غير أني أحدثت لنفسي آلاما متعبة”، ولن يفوتني هنا أن أذكركم -للمقارنة بما سبق- بالعادة التي استقبحها في المجتمع المصري، ثم اكتسبها بكاملها هو شخصيا فيما بعد، أو كاد لولا أنها أحدثت له أيضا آلاما متعبة؛ وهي عادة تلاوة المصريين لآيات وأحاديث تناسب المقام، وقد أوردت بالفعل بعضا من هذه التلاوات الكثيرة. ويهمنا في فقرة الشعور الجامح، إن جاز لنا أن نسميها بهذا الاسم، هذان المقطعان الدالان: “دون أن يتبين أمري”، و”إلى حد لا يثير الشبهة”.
والسؤال الآن: ما هو الشيء الذي أوصل إدوارد إلى هذه الدرجة من القلق؟ أرآه أحدكم إلا متحمسا للذكر في حلقة مخصصة لذلك؟ وإن قلتم: لعلها الديانة؛ فاسمه فقط كفيل بالإفصاح عن مسيحيته، وأجيب بأنه عرف -كما أخبرنا- كيف يلزم العامة أن يعاملوه معاملة المسلم، وأنه لم يعش في مصر باسم إدوارد، بل باسم يقول عنه: “وبعد إتمامها قدموها باسمي الشرقي الذي اتخذته لنفسي”، ولجملته السابقة قصة طريفة، يحكي فيها عن صديقه الكتبي الفضولي، الذي ورطة في عمل “خاتمة” إكراما لسيدنا الحسين، دامت قراءتها تسع ساعات تقريبا، ودفع لكل قارئ من فقهاء الخاتمة الأربعة قرشا وشمعة وبعض الخبز؛ والسبب في ذلك أن صديقه هذا “أراد أن يجعلني مسلما ورعا”، وقد بحثت عن هذا الاسم الشرقي، واكتشقت عموميته ومطابقته للوصف الذي اختاره له، أما الديانة فقد سرد بخصوصها واقعة في أثناء زيارته لمسجد الحسنين: “وسمعت رجلا يصيح: ” نصراني! كافر! ” فاستنتجت أن أحد الزائرين المسيحيين انكشف أمره، وتوقعت فتنة عظيمة. ولكني عندما سألت أحد الواقفين بجانبي عما حدث، قال لي أن هذه الكلمات لم تكن غير سباب بين مسلمين أساء أحدهما إلى الآخر”، ويضيف بعد عودة النظام بين الناس: “ورأيت أن الحكمة تقتضي ألا أوجه أسئلة أخرى”. ولو قارنا بين فقرة السباب، إن جاز لنا أن نسميها بهذا الاسم، وبين فقرة الشعور الجامح لوجدنا أن موقفه في الأولى كان أصعب، ورغم ذلك أظهر رباطة جأش ممتازة، وأن وتبريراته في الثانية كانت أعلى صوتا، رغم أن الموقف لم يكن يستدعي كل هذا القلق. والسؤال الآن: هل ترون مثله أن الملابس التركية كانت أكثر ملاءمة له؟ وهل السيف الذي كان يتقلده ضروريا؟
ثمة سؤال ثالث نراه الأكثر أهمية: هل تأثرت نظرة إدوارد وليم لين للمصريين، أو منصور أفندي كما أحب أن ينادوه به، بقراءته لقصص “ألف ليلة وليلة”؟
أظن أن الأمر يحتاج إلى المزيد من التأمل.
-7-
لم تكن مشاركة إدوارد، إذن، في حلقة الذكر إلا لشعوره بدَفْعَة لا تقاوم، أو -حسب تعبير المترجم- لمحاولة فعل الشيء نفسه، دون أن يُلاحظ كدخيل “without being noticed as an intruder” وهل استطاع ذلك؟ نعم، نجح بإجادة تكفي لعدم جذب الانتباه.
“I succeeded well enough not to attract observation”
فما الذي خرج به من هذه التجربة؟ أسبر -مثلا- غورها، أو تماس مع محيطها الخارجي، أو توصل إلى ما يشتبه أن يكون فلسفتها؟ لا شيء إطلاقا مما سبق، سوى أنه جلب لنفسه حرارة غير مريحة، أو حسب تعبير المترجم “آلاما متعبة”. ولم ير أيضا في صلاة المأمومين خلف إمامهم -في موضع آخر من الكتاب- إلا تقليدا لحركاته. وفي فصل اللغة والآداب والعلوم، وهو الفصل الذي ذكر في هامشه أن البارون هامر برجستال لاحظ نقصه؛ فكان رده عليه في الهامش أيضا: “وكان بودي أن أزيد فيه لولا شعوري بواجب التقيد برغبة القارئ. وأخشى أن أكون قد استنفدت صبره بتسجيل موضوعات لا تهم غير المستشرقين”. ولم يكتف بتبريره العجيب هذا، بل أردف: “وقد صرح لي بعض المصريين الذين تلقوا علومهم في فرنسا أنهم ما كانوا يستطيعون أن يسيغوا شيئا مما تعلموه هناك في عقول مواطنيهم حتى الأقربين إليهم”. والسؤال الآن: ما هي الأمور التي تهم المستشرقين؟ إنها الآتي: الثلاثمائة شخص العائشين في زاوية العميان بالأزهر الذين يُعرفون بسلوكهم طريق التمرد والعنف والتعصب، أهمية الأدب العربي في كمية كتبه أكثر مما هي في كيفيتها، “لا يوجد فرق كبير بين اللهجة الدارجة والفصحى كما يفرض المستشرقون”، “تفصل الخرافة في أمور اختلف فيها العلماء أجيالا طويلة”، “ليس للمصريين معرفة بالجغرافيا إلا فئة قليلة”، ولم يذكر اسم الشيخ حسن العطار إلا “تنفيذا لوعد قطعته على نفسي، إذ طلب أن أنوه بمعرفتي له”. و”قلما يعرف علماء مصر تاريخ بلدهم معرفة جيدة”، وأشياء أخرى تختلف تماما عن ملاحظات جاسبار دي شابرول الآتية: “معرفة أوربا بالأدب العربي معرفة بالغة الضآلة لدرجة لا تسمح بتكوين فكرة دقيقة عن ذلك العدد الكبير من الكتاب المشهورين الذين برعوا في مختلف ضروب المعرفة”، و”أما النحو والبلاغة فقد بقاموا في دراستها بأبحاث عميقة”، “رجال الطبقات الشعبية في مصر، بل وحتى الأطفال لديهم حساسية فائقة لهارمونية الإيقاع”، “لعمال المدن أغنيات خاصة تساعدهم على إنجاز العمل”، “ومن بين التكوينات البالغة الجمال نشير إلى الموال، وهو الأغنية المفضلة لدى الجنس اللطيف في مصر”. كتب جاسبار كل هذا، رغم أنه لم يكن لديه صديق كتبي فضولي.


يتبقى شيء أخير: وهو تأثير “ألف ليلة وليلة” على إدوارد وليم لين، وهو الذي ترجمها للإنجليزية، وأُشار -أو أشار ناشره- إلى ذلك على غلاف كتابه الذي نتحدث عنه، أعنى في طبعته الإنجليزية، ويبدو هذا التاثير جليا في قصص كتابه؛ فما ذكره -في القصة التي اختارها من بين القصص الكثيرة التي رويت له- عن مكائد المصريات أقرب إلى الجو الأسطوري منها إلى الحقيقة. والرواة الكثيرون الذين نقلوا إلى إدوارد قصص المكائد إما أن يكونوا مصريين؛ فنذكره ب”قلما” التي كانت سببا لافتخاره في قصة الصائع الأرمني، أو غير مصريين؛ فيحق لنا أن نسأله عن دوافعهم، أما احتسابهم ضمن القلة الصادقة فيتعارض بطبيعة الحال مع كثرتهم. إدوارد أيضا أنهى -بتكلف واضح- كل قصصه عن السحرة باعترافات المخطئين، حتى لا يفتح على نفسه أمام قرائه بابا للتشكيك في مصداقيته، ليس هذا كل شيء؛ ففي فصل الطفولة وتربية الأطفال يعقب إدوارد علي حكاية محفظ القرآن الذي أخطأ؛ فاشتهر بحكمته: “وقد وجدت بعد ذلك قصة تكاد تشبه هذه الحادثة تماما في كتاب “ألف ليلة وليلة” طبعة القاهرة؛ ولذلك إما أن تكون القصة التي بلغتها غير صحيحة، وإما أن يكون الرجل المشار إليه مقلدا للقصة السابقة”. أكتفي بهذا القدر من الدراسة، وأنصح الراغبين في مطالعة هذا الكتاب بقراءة ملحق المحدثات الأخيرة قبل مقدمة المترجم.
نُشر طبقاً لبروتوكول النشر الدولي المشترك مع مجلة "آسيا إن"

التعليقات